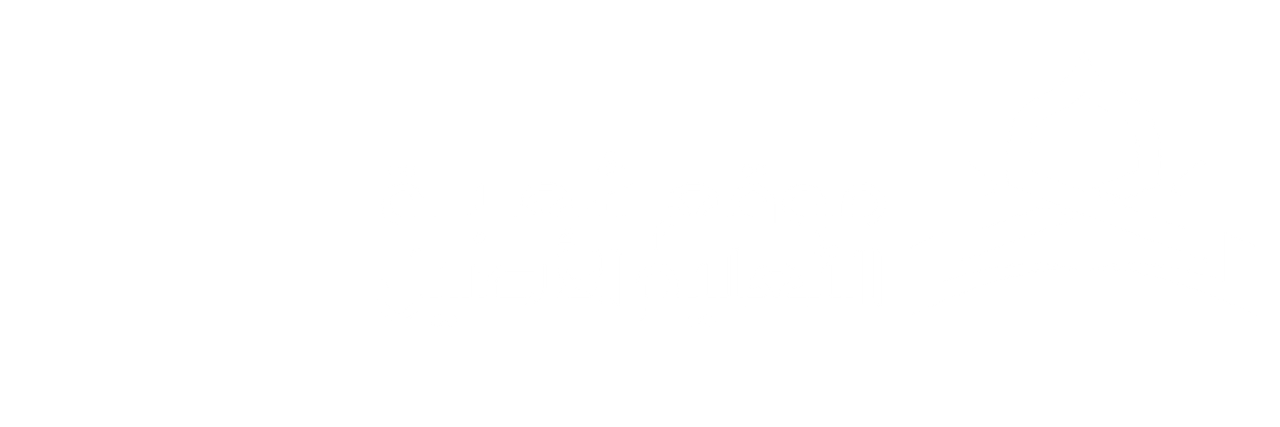الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
التعليم الأصيل يمثل في المنظومة التعليمية والتربوية المغربية، مظهرا من مظاهر التشبث بالهوية الإسلامية والحضارية للمغرب، وتشكل المواد الإسلامية ومواد اللغة العربية نواته المركزية، مما يجعل منه نمطا تعليميا خاصا في هيكلته وتنظيمه التربوي… ويتكون التعليم الثانوي الأصيل من ثلاث شعب : شعبة اللغة العربية؛ شعبة العلوم الشرعية؛ وشعبة التوثيق( هذه الشعبة غير موجودة في الواقع) والمكتبة ( الكتاب الأبيض، الجزء الرابع، المناهج التربوية لقطب التعليم الأصيل)
وينص الفصل 88 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين على ضرورة إحداث مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي، مع مد الجسوربين الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي الأصيل وشعب التعليم الجامعي ذات الصلة، على أساس التنسيق والشراكة والتعاون بين تلك المؤسسات والجامعات.
وحسب المادة السابعة من قانون الإطار، فالتعليم الأصيل يندرج ضمن التعليم المدرسي التابع لقطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي، كما نصت المادة الثامنة منه أن التعليم المدرسي يشتمل على التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي.
وبما أن التعليم الأصيل ضمن التعليم المدرسي، فكل الإجراءات التي سيخضع لها التعليم المدرسي بمكوناته، سيخضع لها التعليم الأصيل من تعميم التعليم الأولي وغير ذلك.
وتجدر الإشارة أن من المواد الإسلامية المدرسة بالتعليم الأصيل: السيرة النبوية، العقيدة، الفقه، أصول الفقه، التفسير، الحديث، الفرائض، التوقيت، التوثيق…، غير أن الإشكالية أن هذا النوع من التعليم من وجهة نظري لم يلق الرعاية الديداكتيكية والبيداغوجية اللازمة مثل التعليم العصري.
وليس قصدي هنا تبخيس الجهود المبذولة لمحاولة رد الاعتبار لهذا النوع من التعليم، كما ليس قصدي الحث على منافسة التعليم العصري على وجه العموم ومادة التربية الإسلامية على وجه الخصوص، فهما متكاملان، وإنما قصدي التنبيه إلى خطورة إغفال هذا النوع من التعليم، وما قد يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على واقعه ومستقبله.
وسأتناول هذا الموضوع من خلال تبيان بعض مظاهر إغفاله في التناول الديداكتيكي والبيداغوجي، ثم خطورة إغفال تناوله على مستقبل هذا النوع من التعليم بعد ذلك.
المطلب الأول : مظاهر إغفال التعليم الأصيل ديداكتيكيا وبيداغوجيا:
المتتبع والمواكب للشأن التربوي عامة، وما يتعلق بالتعليم الأصيل خاصة، سيلحظ أن هناك تقصير في تناول التعليم الأصيل والاعتناء به، والسبب في ذلك قد يعزى إلى قلة مؤسسات التعليم الأصيل مقارنة بمؤسسات التعليم العصري، كما قد يعزى إلى تقصير من طرف المهتمين به بقصد أو بغير قصد، ومن مظاهر إغفاله:
- أولا: إغفاله في التوجيه المدرسي:
في الوقت الذي تكون فيه باقي الشعب معلومة لدى المتعلمين قبل اختيار شعبة معينة في الجذع المشترك، فقد تجده لا يعلم بوجود شعبة اسمها التعليم الأصيل، وإن علم بها فقد يسأل عن هذه الشعبة وآفاقها، فيجيبونه بأنها كشعبة الآداب من حيث بعض المواد المدرسة بها ومن حيث آفاقها، وإن أضافوا شيئا من الشرح قالوا أنها تعرف توسعا في مادة التربية الإسلامية.
وإن كانت هذه الأسئلة والأجوبة تبدو منطقية على الأقل بالنسبة للمتعلم، فإن خطورتها تتجلى في أن المتعلم هنا وضع بين خيارين: بين شعبة بعيدة _ بعض المديريات بها مؤسسة واحدة بها التعليم الأصيل كثانوية تيفارتي بأزيلال، وبعض المديريات لا تتواجد بها هذه الشعبة كالمديرية الإقليمية بإقليم الدريوش_ عن محل سكناه في الغالب( شعبة التعليم الأصيل) وهي كشعبة الآداب تماما كما شرحت له، وبين شعبة الآداب القريبة من محل سكناه، وهذا في أحسن الأحوال، وقد لا يعلم بتاتا بوجود هذه الشعبة.
- ثانيا: إغفاله في امتحانات ولوج التعليم:
من المعلوم أن التعليم الأصيل يندرج ضمن التعليم المدرسي، وهو تابع لوزارة التربية الوطنية- عكس التعليم العتيق التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- ، والامتحان الذي يجتازه المترشحون لمباراة التعليم تخصص مادة التربية الإسلامية هو نفسه الذي يجتازه المدرسون للمواد الإسلامية بالتعليم الأصيل فيما بعد، غير أن الوزارة لا تميز بين من سيدرس التربية الإسلامية وبين من سيدرس التعليم الأصيل.
فامتحانات ولوج المراكز الجهوية تتضمن مادتين: مادة التخصص وديداكتيكها -وهي هنا مادة التربية الإسلامية- ومادة علوم التربية، والمطلع على نماذج هذه الامتحانات، سيجد تغييب للمواد الإسلامية المدرسة بالتعليم الأصيل وديداكتيكها، فإن كان المترشح يسأل في بعض العلوم الشرعية كالفقه والأصول والتفسير والحديث…، فإنه لايسأل في بعض هذه العلوم والتي تدرس بالتعليم الأصيل كالتوقيت والتوثيق، ويتضح هذا التغييب أكثر في أسئلة ديداكتيك التخصص فهو يسأل في ديداكتيك مادة التربية الإسلامية، ولا يسأل ولو سؤالا واحدا في ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم الأصيل، كأسماء المواد الإسلامية المدرسة بها على الأقل.
وقد يعلل ذلك مرة أخرى بقلة مؤسسات التعليم الأصيل، وأنه قد تجد مترشحا واحدا ضمن الفوج بأكمله هو الذي سيكلف بالتدريس بالأصيل، فكيف نثقل كاهل الفوج بأكمله بديداكتيك الأصيل، وقد نتساءل لماذا لا تنظم مباراة خاصة بالتعليم الأصيل؟ فيجاب عن سؤالنا هذا وهل سيبقى هذا المدرس طيلة حياته يدرس التعليم الأصيل، فقد ينتقل إلى مؤسسة أخرى ليس بها التعليم الأصيل فيدرس مادة التربية الإسلامية، وقد يكون الحل المقترح أن الجميع سيتلقى تكوينا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في ديداكتيك مادة التربية الإسلامية وديداكتيك المواد المدرسة بالأصيل، وقد يتلقون دعم تكوين الأساس في بعض هذه المواد المدرسة بالأصيل كمادة التوقيت والتوثيق، وبذلك يكون الجميع مستعدا لتدريس التربية الإسلامية وتدريس المواد المدرسة بالأصيل، ويبقى السؤال هل يتلقى الأستاذ المتدرب تكوينا مزدوجا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يجمع بين التكوين لتدريس التربية الإسلامية والتكوين لتدريس التعليم الأصيل ؟
- ثالثا: إغفاله في مراكز تكوين الأساتذة:
لماكنت أستاذا متدربا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كنت أظن بعد ولوجي للمركز أن ديداكتيك المواد المدرسة بالأصيل ستكون حاضرة في رزنامة التكوين، لكن ذلك لم يحدث، وخاب ظني أكثر لما توجهت إلى مكتبة المركز الجهوي قصد إعارة مقررات التعليم الأصيل_مقررات التعليم الأصيل غير متوفرة في المكتبات، حسب علمي توجد بالحبوس بالدار البيضاء فقط_ فلم أجدها، وقد تواصلت مع بعض زملائي ببعض المراكز الجهوية الأخرى على الصعيد الوطني فأخبروني بعدم إدراجها ضمن التكوين.
بينما نجد في بعض المواد كالاجتماعيات والفيزياء مثلا، تكون مجزوءة دعم التكوين الأساس في المادة التي لم يدرسها الأستاذ المتدرب في الجامعة،كأن يكون تخصصه في الجامعة التاريخ فيدعم في المراكز في الجغرافيا أو العكس، أو يكون تخصصه الفيزياء فيدعم في الكمياء…، لأنه سيدرس هذه المواد بعد تخرجه من المركز.
والمنطق يقتضي أن يدعم الأستاذ المتدرب في تخصص التربية الاسلامية في بعض المواد التي لم يدرسها في الجامعة، والتي يمكن أن يدرسها بعد تخرجه كمادة التوقيت والتوثيق بالتعليم الأصيل مثلا، غير أن مجزوءة دعم التكوين الأساس بالمراكز الجهوية تعاني من إشكال وهو أن اختيار ما يدرس بهذه المجزوءة يوكل للأستاذ المكون، فقد يختار مادة يتقنها، أو له فيها كتاب، فيكون هو المقرر، كأن يختار التجويد أو الحديث…، ويبقى الإشكال ماذا لوكلّف هذا الأستاذ المتدرب بالتدريس بالتعليم الأصيل بعد تخرجه ؟ قد يجيبونك على هذا السؤال بأنه سيتلقى تكوينا مستمرا ومواكبة تربوية من طرف المؤطر التربوي، فنتساءل هل يتلقى المفتش المتدرب تكوينا خاصا بالتعليم الأصيل في مركز تكوين المفتشين ؟
- رابعا: شبه إغفاله في مراكز تكوين المفتشين:
تواصلت مع المؤطر التربوي الدكتور ادريس بوحوت، وسألته هل يتلقى المفتش المتدرب تكوينا بمركز التفتيش ؟ فأخبرني أنه فعلا ينجز المفتشون المتدربون عدة أعمال وندوات... في موضوع التعليم الأتواصلت مع المؤطر التربوي الدكتور ادريس بوحوت، وسألته هل يتلقى المفتش المتدرب تكوينا بمركز التفتيش ؟ فأخبرني أنه فعلا ينجز المفتشون المتدربون عدة أعمال وندوات… في موضوع التعليم الأصيل، غير أنني أتصور وجود تقصير مرة أخرى ولو بدرجة أقل في حق التعليم الأصيل _ وإن كان هذا الحكم يحتاج إلى دراسة لما يدرس وينجز بمركز تكوين المفتشين في علاقته بالتعليم الأصيل_ ذلك أن التعليل بأن مؤسساته قليلة قد يحضر في كثير من المواقف.
ولازلت أتذكر لما كنت تلميذا بالثانوي التأهيلي شعبة العلوم الشرعية بالتعليم الأصيل، زارت لجنة تفتيشية أحد أساتذتي، علمت فيما بعد من طرف أستاذي إبراهيم الزبيري أن تلك الزيارة هي لامتحان الكفاءة التربوية، قلت لازلت أتذكر أن الأستاذ قدم درسا في مادة التوقيت، فكانت اللجنة من المستمعين أو هكذا فهمت إذ ذاك.
- خامسا: إغفاله في اللقاءات التأطيرية والدورات التكوينية والندوات:
لم يحظ التعليم الأصيل بحقه في اللقاءات التأطيرية والدورات التكوينية والندوات كالتعليم العصري، وقد حضرت لقاء تربويا- كأستاذ لمادة التربية الإسلامية – مؤطر من طرف المفتش التربوي حول موضوع:” التقويم الإشهادي في مادة التربية الإسلامية”، وحضره أساتذة التعليم الأصيل بالإقليم، ولم يتطرق المؤطر التربوي إلى ما يتعلق بالتعليم الأصيل.
صحيح هناك لقاءات تربوية ودورات تكوينية كالدورة التكوينية التي نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس، لفائدة أساتذة العليم الأصيل الجديد، وذلك أيام 31 أكتوبر و1-2نونبر 2019 م، بمركز التكوينات والملتقيات بفاس تحت شعار: “التعليم الأصيل الجديد دينامية متجددة لتحقيق التميز“، وكالملتقى الوطني السابع لمؤسسات التعليم الأصيل الجديد بالمغرب، وذلك أيام: 19– 20أبريل 2019م، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، فرغم هذه الجهود المبذولة إلا أنه تبقى غير كافية، إما للمدة الفاصلة بين اللقاءات، أو لكونها تنظم فقط في بعض الأكاديميات والمديريات مما يتعذر على المهتمين بها حضورها.
- سادسا: إغفاله في المقالات والبحوث الأكاديمية:
المتتبع للمقالات والبحوث التي تنجز في مراكز التكوين- بحوث التخرج مثلا – أو في الإجازة المهنية في التربية، أو في ماسترات الخاصة بالتربية، أو في مقالات المؤطرين التربويين…، سيلحظ لامحالة تقصيرا بخصوص التعليم الأصيل، صحيح بعض هذه البحوث تتناول تدريس العلوم الشرعية عامة، لكنها تقصد بالأساس العلوم الشرعية المدرسة بالجامعات المغربية، فقد نجد من بين تلك البحوث من يبحث في منهجية تدريس: القواعد الفقهية، مقاصد الشريعة، الفقه، السيرة…
ولعل السبب في ذلك من وجهة نظري أن التعليم الأصيل يخص فئة قليلة من المجتمع، والبحث ينبغي أن يظهر أنه يخاطب فئة عريضة من المجتمع حتى تكون له قيمة علمية أو هكذا يبدو.
والتحقيق أن التعليم الأصيل مجال خصب للبحث التربوي، ينبغي على الباحثين خوضه ونفض الغبار عنه، وتبيان طرائق وأساليب تدريس مواده وتقويمها…
- سابعا: إغفاله في العمل الجمعوي:
كثيرة هي الجمعيات التي تشتغل في المجال التربوي ولها علاقة بمادة دراسية معينة، كالجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض…، وهذه الجمعيات تعمل على إغناء المادة بالبحوث التربوية، وتنظيم وتأطير دورات وندوات لتحسين وتجويد العمل التربوي…، وأحيانا تقف للدفاع عن المادة حينما يتخذ قرار معين ليس في صالحها…
غير أن الجمعيات التي تعنى بالتعليم الأصيل شبه منعدمة، فلابد من إحياء الجمعيات المؤسسة سابقا، وتوحيد الجهود، أو على الأقل تأسيس جمعية وطنية تضم قدماء وأساتذة والمهتمين بالتعليم الأصيل، وتكون فروعها على صعيد الأكاديميات أو المديريات، مع القطع مع الجمعيات التي يكون هدفها الاسترزاق بملف التعليم الأصيل، والتي تظهر بثوب البطل الغيور عليه.
هذه بعض مظاهر إغفال هذا النوع من التعليم كما يبدو لي، وأكد مجددا أن هدفي ليس تبخيس الجهود المبذولة بخصوص التعليم الأصيل، وإنما القصد هو التنبيه إلى ضرورة مزيد الاعتناء به.
المطلب الثاني: خطورة إغفاله في التناول البيداغوجي والديداكتيكي:
لاريب أن إغفال التعليم الأصيل قد يترتب عن ذلك نتائج سلبية على واقعه وعلى نظرة الناس إليه، وعلى مستقبله أيضا، ومن نتائج إغفاله:
- أولا: تكريس التدريس ببيداغوجيا الأهداف:
من المعلوم أن المنظومة التربوية المغربية قد قطعت مع بيداغوجيا الأهداف، وتعول كثيرا على المقاربة بالكفايات كخيار استراتيجي، غير أن إغفال هذا التأطير الديداكتيكي والبيداغوجي في تكوين المتدخلين من مفتشين ومدرسين… قد يكرس تدريس المواد الإسلامية ببيداغوجيا الأهداف تخطيطا وتدبيرا وتقويما، وهي الصورة الأولية التي يمتلكها البعض عن التعليم الأصيل والتعليم العتيق أيضا، فحينما يريد مثلا أن يمثل أحدهم لبيداغوجيا الأهداف، تجده يمثل بالتعليم الأصيل والتعليم العتيق.
وقد لوحظ مؤخرا انتقاد تدريس العلوم الشرعية بالجامعات المغربية وأن بعض الأساتذة الجامعيين يدرسون وفق التدريس بالأهداف، دون اعتماد طرائق وتقنيات التدريس الحديثة، كما يلاحظ ذلك من خلال أسئلة الاختبارات التي تهم الجانب المعرفي بالأساس، مما يستدعي أن يتلقى الأستاذ الجامعي تكوينا بيداغوجيا أساسيا أو مستمرا، والحقيقة أنه إذا كان هذا المدرس وهو يتعامل مع فئة معينة من الطلبة – يمتلكون كفايات منهجية وتواصلية وثقافية… لابأس بها مقارنة بطالب بالثانوي التأهيلي الأصيل- بحاجة إلى التكوين، فمدرس هذه المواد بالتعليم الأصيل أكثر حاجة إلى التكوين من مدرس العلوم الشرعية بالجامعات.
- ثانيا: تكليف بعض المدرسين والمؤطرين غير المؤهلين:
غياب أو شبه غياب التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة المدرسين والمؤطرين المكلفين بالتعليم الأصيل، قد ينتج عنه ضعف ديداكتيكي وبيداغوجي- وللأمانة فجميع الأساتذة الذين درسوني المواد الإسلامية بالتعليم الأصيل بالإعدادي والتأهيلي من المشهود لهم بالكفاءة المعرفية والأخلاقية والتربوية- في تدريس المواد الإسلامية، وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، وكيف تلومه وهو لم يتلق أي تكوين خاص بالمواد الإسلامية المدرسة بالتعليم الأصيل.
فلا أحد يستطيع أن ينكر أهمية تلقي المدرس تكوينا بيداغوجيا تخطيطا وتدبيرا وتقويما، والتدريس على يد أستاذ لم يتلق أي تكوين بخصوص تدريسية المواد بالتعليم الأصيل، قد لا يحقق لنا المواصفات المطلوبة من التعليم الأصيل، ومن مواصفات التعليم الثانوي التأهيلي مسلك العلوم الشرعية كما نصت على ذلك التوجيهات والبرامج الخاصة بتدريس المواد الإسلامية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي الأصيل يوليوز 2007 :
القدرة على التواصل مع الآخرين والدفاع عن الرأي الشخصي؛
اتخاذ واقف إيجابية تجاه المحيط الاجتماعي والطبيعي والثقافي من خلال توظيف المعارف والكفايات المكتسبة في إطار من التفاعل الإيجابي.
التمكن من المنهج العلمي في الفهم والاستنباط والتوثيق
التمكن من مفاهيم التحليل والاستنتاج، ومن مهارات الاستدلال والبرهنة والحكم القويم.
التمكن من توظيف الثقافة العربية الإسلامية والانفتاح على مختلف الثقافات…
فأنى له بهذه المواصفات وغيرها إن كان مدرسه لم يتلق أي تكوين بخصوص تحقيقها؟
- ثالثا: تكوين صورة غير صحيحة عن التعليم الأصيل وعن طلبته وأساتذته:
لعل من الأسباب التي قد تجعل الإقبال على التعليم الأصيل ضعيفا، هو تكوين صورة خاطئة عنه، وهذه الصورة ناتجة عن عدم التعريف به وتبيان مزاياه وآفاقه…، فتجد البعض يعتقد أن التعليم الأصيل يلجها فقط المنقطعون والمطرودون من مؤسساتهم، بل قد تجد بعض أساتذة مادة التربية الإسلامية لا يعرف عن هذا النوع من التعليم شيئا، فكيف سيشجع المتعلمين على اختياره في التوجيه مثلا، كما أن البعض الآخر لا يميز بين التعليم الأصيل والتعليم العتيق.
وهذا التصور الغالب الذي لدى البعض تجاه طلبة التعليم الأصيل وأساتذته من كونهم لا ينفتحون لا على اللغات الأجنبية ولا على المواد العلمية، والعصر الحالي عصر اللغات وعصر العلوم، فينبغي أن يصحح هذا التصور، لأنه قد يكون سببا في عدم الإقبال عليه.
- رابعا: إغلاق بعض مؤسسات التعليم الأصيل وبعض الأقسام الداخلية:
هذا نتيجة كل ما تقدم، فكثيرة هي المؤسسات التي تحولت من التعليم الأصيل إلى التعليم العتيق ( كمؤسسة التعليم الأصيل بالزاوية الناصيرية بتمكروت بزاكورة) أو كانت خالصة وخاصة بالتعليم الأصيل، ثم أصبحت مختلطة بالشعب الأخرى، وهذه الطريقة لاشك قد تؤدي إلى اندثار هذه الشعبة وتراجعها
خاتمة:
لن أعيد تكرار ما ذكرته سابقا، وإنما أخصص هذه الخاتمة لمجموعة من الاقتراحات أهمها:
ضرورة التفكير في تأسيس جمعية وطنية تضم الغيورين على هذا النوع من التعليم.
إعطاء التعليم الأصيل حقها من التوجيه المدرسي.
أهمية التكوين الأساس والمستمر لفائدة المتدخلين في التعليم الأصيل.
ضرورة تصحيح التمثلات حول التعليم الأصيل من خلال عقد دورات وندوات وملتقيات.
المطالبة بفتح مؤسسات أو شعب التعليم الأصيل في كل مدينة أو على الأقل في كل مديرية إقليمية مع توفير القسم الداخلي للذكور والاناث.
الاعتناء بهذا النوع من التعليم في جميع الأسلاك والحفاظ على هويته الحقيقية.
التعليم الأصيل ونظيره العصري متكاملان وينبغي الاعتناء بهما معا.
ضرورة تعميم التعليم الأولي والابتدائي الأصيل وفق ما جاء به قانون الإطار.
____________________
المصادر والمراجع:
-الميثاق الوطني للتربية والتكوين
-كتاب الأبيض، الجزء الرابع، قطب التعليم الأصيل.
-قانون الإطار رقم 17.51